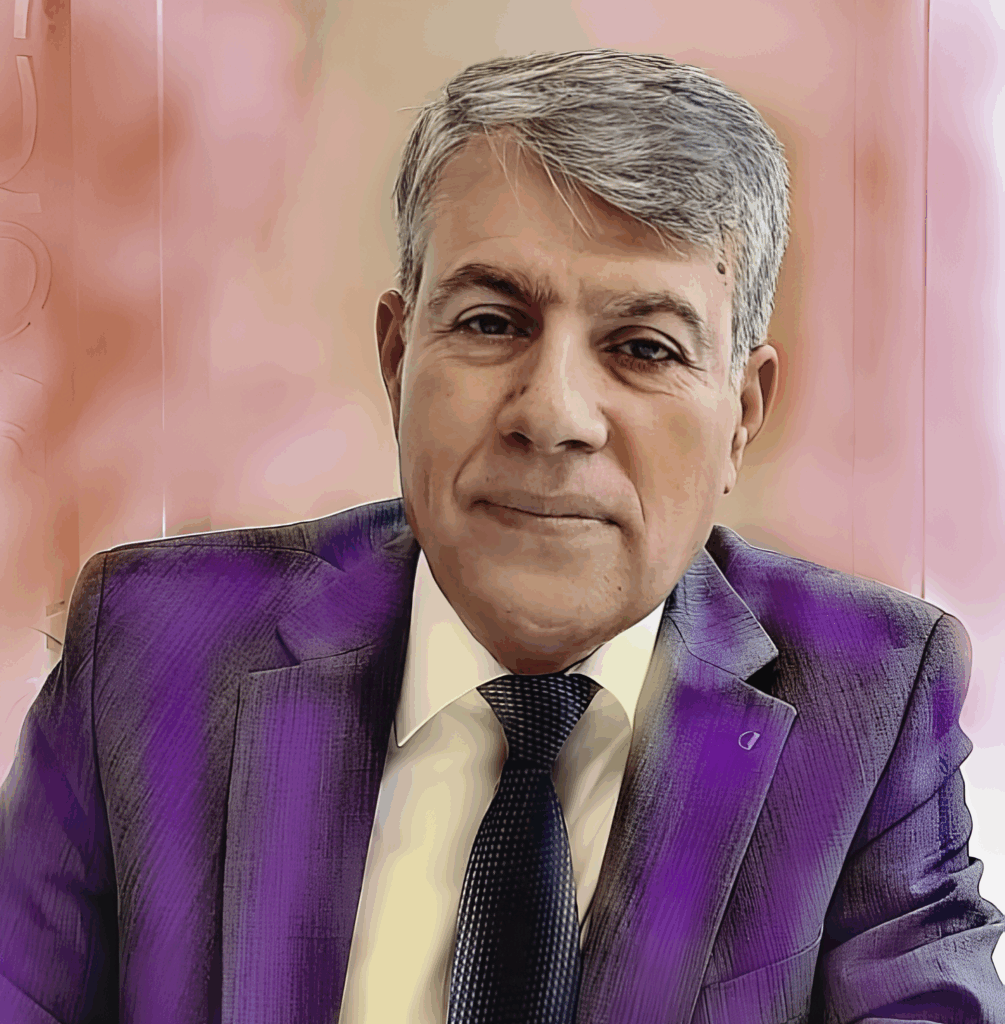عبد الكريم البليخ
داهمتني فكرة موجعة، فكرة تحوّلت إلى طيفٍ مقيمٍ في ذهني لا يبرحه، تطارده ذاكرتي فتفرُّ إلى حواسي، ثم تعود لتشتعل لهباً في وجداني. إنها فكرة تشويه صورة المثقفين في العالم العربي، ذاك التشويه الذي لا يستهدف أفراداً بقدر ما يستهدف الطبقة الحاملة لمشروع الأمة في التقدم والتطور والنهضة.
محاولة إسكات هذا الصوت ليست وليدة اليوم، بل تمتد بجذورها إلى عمق التجربة التاريخية للأمم المستعمَرة والمقهورة. ففي الغرب، عرفوا هذه اللعبة القذرة مبكراً، حين أدركوا أنَّ القضاء على حركة وعي جماهيري يبدأ بتدمير رموزه الثقافية. أما نحن، ففي تراب هذا الشرق المنهك، كان عبدالله النديم، مثال الأديب المفكر والفنان الثائر، أول من ذاق مرارة هذه اللعبة الخبيثة.
عبدالله النديم، الذي عاش بين شوارع القاهرة وأزقة قراها المنسية، لم يكن مجرد أديب عابر، بل كان ضمير أمة يُصغي لصرخات المصريين والفلاحين المكويين بنار الاستعمار. تسع سنوات كاملة قضاها متنقلاً خفيةً بين القرى، متوارياً عن أنظار المحتل البريطاني بعد احتلال 1882، يمارس مقاومته عبر الكلمة الحارقة، الكلمة التي كانت تخترق جدران القهر وتزرع بذور الأمل. وحين عفا عنه الخديوي توفيق لفترة قصيرة، لم يكن العفو إلا قيداَ آخر، إذ انتهى المطاف بالنديم مطروداَ من وطنه، منفياً إلى تركيا، ليموت هناك وحيداَ، بلا قبر يضم غربته الأبدية.
وفي المعمار النفسي للمثقف العربي، تتجسد مأساة النديم كصورة حية للاغتراب المركب: اغتراب في وطنه حين كان مختفياً بين أهل قريته، واغتراب في المنفى، حين صار طيفاَ غريباَ في أرض لا يعرفها. هكذا، انبنى وعي المثقف العربي على خوف دفين، وجرح مفتوح: خوف من الخيانة الداخلية، وجراح التشويه الخارجي.
تاريخ هذا التشويه يتكرر، ليس في الشرق وحده، بل امتد إلى الغرب نفسه. تروي مأساة الممثلة الأمريكية جين سيبرج فصلاً آخر من هذا السرد المظلم. جين، الفتاة البيضاء ذات القلب الكبير، التي أبهرت العالم في فيلم “جان دارك”، رمزت إلى براءة الفن حين يتحد بالحق. لكنها لم تكن مجرد ممثلة، بل روحاً مقاومة، انضمت بشجاعة لحركة تحرير الزنوج في أمريكا، تلك الحركة التي كانت شوكة في حلق العنصرية المؤسسية.
في سرديات جين، نرى تكراراً للسيناريو ذاته: حين أرادت أن تكون صوتاً للعدالة، أطبقت عليها آلة التشويه الإعلامي، فألّفت حولها الحكايات القذرة، ونُسجت الأساطير السوداء عن أخلاقها، حتى شُوّهت صورتها في الوعي العام. أصبحت “مومساً”، “غانية”، “امرأة فقدت شرفها”، بفضل أبواق الظلم، لا لشيء سوى أنها وقفت في صفّ المقهورين. لم تستطع جين أن تنتصر على التشويه الداخلي، الذي تحول إلى سرطان في أعماقها، فاختارت أن تختم حياتها قرب نهر السين، وحيدة، كما تموت الأرواح الطاهرة التي عجزت عن التكيف مع قسوة العالم.
وهكذا، يتضح أن التشويه لا يقتل الجسد وحده، بل يخترق إلى النفس، يُغرقها في دوامات من الشك واليأس، حتى تُدمَّر الذات من الداخل.
ولا يقتصر الأمر على التاريخ الغابر، بل لا تزال يد التشويه تعبث اليوم بوجوه المثقفين العرب. ما قرأته عن الكاتب الكبير الطيّب صالح لم يكن أقل مرارة، إذ طالعني في إحدى المجلات مقال مسموم يفيض بالافتراءات والأكاذيب، يطعن في شرف الكلمة، ويغتال نبل القلم. تساءلتُ: لماذا يحاولون اغتيال الطيّب صالح، هذا النجم الذي أضاء سماء الأدب العربي المعاصر في زمن قلّت فيه الأضواء؟
إن الطيّب، بروحه السودانية الحلوة، وصوته السردي الذي ينقش وجدان القراء بألوان النيل والتراب والحزن الجميل، لم يكن سهلاً أن ينكسر. الطبيعة منحته عزيمة نادرة، فكان يتحمل الطعنات بابتسامة ساخرة ومضى يكتب، مثلما يواصل النهر جريانه رغم صخور الطريق.
لو استسلم الطيّب صالح للحملات المسعورة كما استسلم آخرون، لكنا فقدنا “موسم الهجرة إلى الشمال”، ذاك العمل الخالد الذي كشف عن شروخ الهوية وازدواجية الإنسان العربي المعاصر. ولكن، وللأسف، كم من الطيبين لم يصمدوا أمام زحف الجحود، فتراجعوا، وصمتوا، وغادروا المسرح بصمت مأسوي؟
إنّ الاستعمار الثقافي الحديث أكثر خبثاً من نظيره العسكري. لا يحتاج لرفع رايات الغزو على الأسوار، بل يكفيه أن يحطم “النخبة”، ويفقد المجتمع رموزه وقدواته. إنه استعمار يستهدف “النفس الجمعية”، يغذيها بالريبة، ويزرع فيها بذور الشك. في هذا السياق، تصبح عمليات التشويه اليومية ليست مجرد اغتيالات شخصية، بل حرباً شاملة على وعي الأمة.
ويستخدم هذا الاستعمار أدوات متعددة: من تشويه السيرة الشخصية، إلى السخرية الممنهجة، وصولاً إلى دفع المثقف للتحول إلى “مهرّج” على خشبة الإعلام الجماهيري. حدث هذا مع توفيق الحكيم، الكاتب الذي كان من الممكن أن يكون “أفلاطون العرب”، لكنه، بدافع الرغبة في الشهرة، استسلم لموجة التسطيح. فتحول إلى شخصية هزلية، يتداول الناس طرفه وقصصه المضحكة أكثر مما يتداولون أفكاره ورؤاه.
وهكذا، يحقق الاستعمار هدفه النهائي: تجريد المثقف من قدرته على التغيير، ودفع الجماهير إلى السخرية ممن كانوا يوماً قادتهم الفكريين.
في المدن العربية القديمة، حيث تلتقي الحارات المتعرجة بالمآذن الشامخة والأسواق العابقة بروائح القهوة والعطور، كان المثقف يقف دوماً كمنارة وسط الغبار. لكنّ هذا المعمار الرمزي أيضاً بات مستهدفاً: حين ينهار المثقف، تنهار معه القلاع الفكرية التي تحمي الأمة من السقوط.
لهذا، فإن حماية المثقف اليوم ليست ترفاً ولا ترفقاً، بل ضرورة وجودية. إننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار لكل عبدالله نديم جديد، ولكل جين سيبرج شجاعة، ولكل طيّب صالح عبقري.
علينا أن نتعلم من الدروس القاسية، أن نقف بقوة وعزم أمام آلة التشويه، أن نحمي أصواتنا الأصيلة من الاختناق وسط صخب التزوير والانحطاط. فالمثقف ليس فقط من يكتب قصيدة أو يرسم لوحة، بل هو من يزرع في أرواحنا بذور المستقبل.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سنصحو قبل أن نجد أنفسنا في عالم بلا مثقفين، بلا نجوم تهتدي بها السفن التائهة في ليل الحضارات؟